القيادة الغائبة والإنتفاضة التي طال إنتظارها
- الصفحة الرئيسية
- مقالات و تحليلات
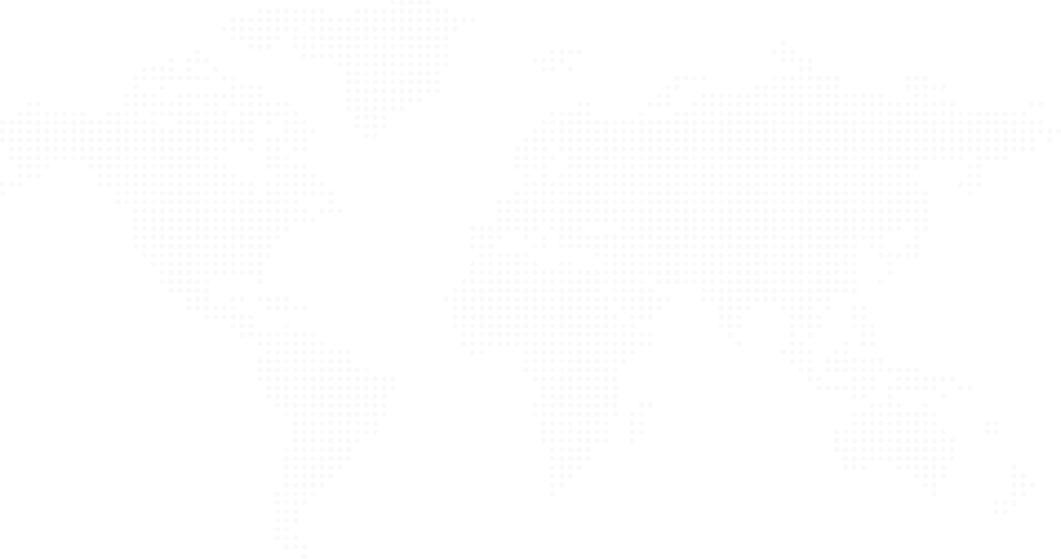
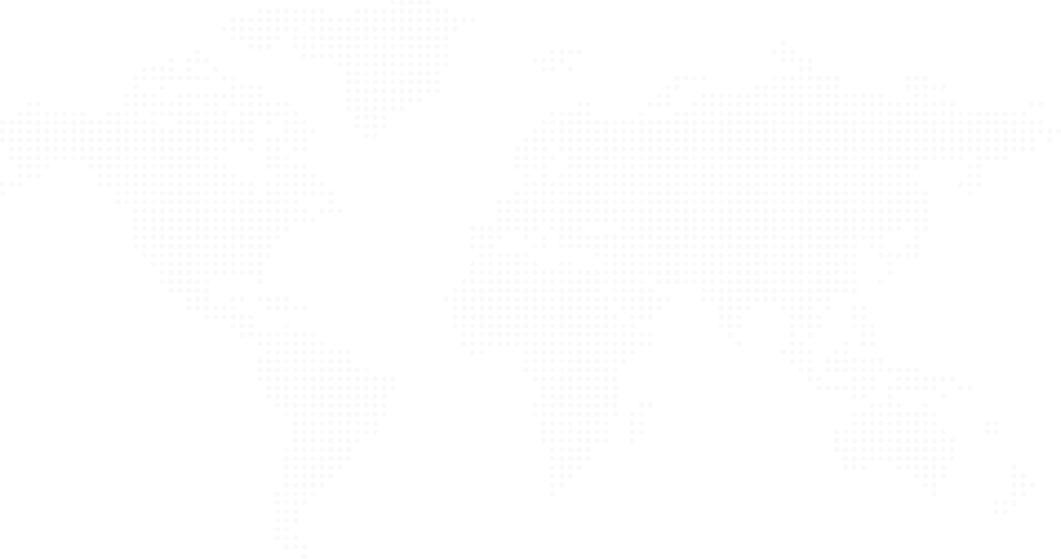

 قَطَعَ نبيل أبو ردينة الشكّ باليقين، عندما أكد جوهريًا، بينما نفى شكلًا، أنّ اجتماع القيادة أُجل إلى إشعار آخر، إنْ لم نقل أُلغي، مثلما ألغيت الانتخابات في نفس هذا الوقت تقريبًا من العام الماضي؛ إذ قال: "إن اجتماع القيادة لم يُلغَ، وقائمٌ على مستويات قيادية متعددة في "فتح" والفصائل الفلسطينية، وكُلِّف الكثير من الزملاء وأعضاء القيادة في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، للقيام بأوسع مدى من الاتصالات لتطويق الموقف، وإيجاد صيغة فلسطينية مدعومة عربيًا".
قَطَعَ نبيل أبو ردينة الشكّ باليقين، عندما أكد جوهريًا، بينما نفى شكلًا، أنّ اجتماع القيادة أُجل إلى إشعار آخر، إنْ لم نقل أُلغي، مثلما ألغيت الانتخابات في نفس هذا الوقت تقريبًا من العام الماضي؛ إذ قال: "إن اجتماع القيادة لم يُلغَ، وقائمٌ على مستويات قيادية متعددة في "فتح" والفصائل الفلسطينية، وكُلِّف الكثير من الزملاء وأعضاء القيادة في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، للقيام بأوسع مدى من الاتصالات لتطويق الموقف، وإيجاد صيغة فلسطينية مدعومة عربيًا".
أي بعبارة أخرى، لا حاجة إلى اجتماع "التنفيذية"؛ لأنه سيضطر إلى رفع السقف للاستهلاك الشعبي، بينما لم تصل الجهود إلى خلاصة، وليست السلطة هي اللاعب الرئيس فيها. كما بدأ تهميشها، أو بالأحرى الإلغاء العملي لها بوصفها مؤسسةً قياديةً عليا منذ سنوات، خصوصًا حينما تحوّلت إلى هيئة استشارية لا يحضر الرئيس معظم اجتماعاتها، بحجة أن العمل جارٍ من دون اجتماعها، وهذا يعطي مصداقية لخبر تمّ تداوله في الكواليس مفاده أن الرئيس محمود عباس أبلغ "التنفيذية" في اجتماعها اليتيم بعد انتخابها بأنه لن يستطيع حضور اجتماعاتها بالمرة، وأن تقسيم العمل، خصوصًا تعيين أمين سر للجنة سيستغرق وقتًا، على خلفية الخلافات حوله، وأنهم إذا احتاجوا إلى شيء فيمكن أن يراجعوا حسين الشيخ، في إشارة بليغة إلى أنّه المرشح الأوفر حظًا لخلافة الراحل صائب عريقات.
وفي كل الأحوال، ما يفهم من تصريح أبو ردينة يطابق واقع الحال، سواء اجتمعت القيادة، أو لم تجتمع، فـ"التنفيذية" غير موجودة على أرض الواقع. أما القرار الفلسطيني الرسمي فهو يتخذ من شخص واحد، بمساعدة عدد من المساعدين.
القيادة لم تعد ذات صلة
ما يرسخ غياب القيادة أنّ الاتصالات واللقاءات الجدية للتوصل إلى اتفاق لاحتواء الموقف، أو منع التصعيد وانفلاته إلى مواجهة شاملة، سواء شعبية وعسكرية، مثلما حصل في أيار الماضي، جرت مع حركة حماس، فهي بيدها قرار التصعيد والتهدئة بالتنسيق مع حركة الجهاد الإسلامي، وهذا يهمّش القيادة الرسمية، ويجعلها أكثر وأكثر ليست ذات صلة.
"حماس": تصعيد في الضفة وتهدئة في غزة
تريد "حماس" تصعيد المقاومة في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، ولا تريد التصعيد في غزة، وهذا يظهر من خلال عدم الإعلان عن إنذار لإسرائيل من تجدد سيف القدس، كما لم يظهر أبو عبيدة الناطق باسم القسام حتى الآن، ولم نشهد تصريحاتٍ ناريةً، ولا مسيراتٍ حاشدةً، ولا بالوناتٍ حراريةً، ولا تصعيدًا ليليًّا، بل هناك حرصٌ، يمكن تَفَهُّمُ أسبابه، على استمرار التهدئة؛ لأن المواجهة مكلفة جدًا، ولا يجب الذهاب إليها إلا عند تصعيد دراماتيكي. فالتهدئة ضرورية لالتقاط الأنفاس، واستمرار عملية إعادة الإعمار التي تقوم بها مصر، وتدفق الأموال القطرية، وذهاب العمال من قطاع غزة إلى العمل في إسرائيل، الذين بلغ عددهم 12 ألفًا، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 20 ألفًا إذا تمت المحافظة على التهدئة، وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من مواصلة تطوير القدرات العسكرية، خصوصًا الصاروخية استعدادًا لأي مواجهة قادمة.
لا يعني التوصل عمليًا إلى التهدئة أنها ستستمر طويلًا، وفي كل الأحوال، وإنما قد تنهار إذا تم ذبح القرابين في الأقصى - وهذا بات مستبعدًا؛ لأن موعد قربان الفصح انتهى مساء السبت الماضي - وإذا سقط عدد كبير من الشهداء، واقتحام كبير لجنين وغيرها من المناطق المتفجرة، وتنفيذ عملية سورٍ واقٍ (2) مصغرة فيها، أو إذا نُفّذت عملية فدائية داخل الخط الأخضر أو في الضفة المحتلة وسقط جرائها عددٌ كبيرٌ من القتلى الإسرائيليين.
وفي هذا السياق، لم تنفذ سلطات الاحتلال تهديداتها باقتحام جنين؛ خشية من الخسائر المترتبة على المقاومة، ومن امتداد المعركة إلى قطاع غزة.
إحباط قربان الفصح... أما التقسيم الزماني فمستمر
يبدو هناك تفاهم ضمني على التعايش مع التصعيد الحالي، والمسؤول عنه، أساسًا، سلطات الاحتلال التي تريد الاستمرار في فرض التقسيم الزماني الذي فرضته منذ سنوات، مع إصرار هذه المرة على إبعاد المعتكفين عند اقتحام اليهود للأقصى، وصولًا إلى التقسيم المكاني في الأقصى، على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي، إلى أن يتم في المستقبل بناء "هيكل سليمان" المزعوم، إلى جانب الأقصى، أو على أنقاضه.
يجب عدم إسقاط احتمال أن نصحى في أحد الأيام ونرى أن التقسيم الزماني والمكاني قد تم تكريسه، فإشاعة الأجواء عن العزم على تقديم القرابين حينًا، ونفيها أو منعها حينًا آخر، يحرف الأنظار عما يجري على الأرض منذ سنوات من تقسيم زماني؛ حيث تقوم العشرات والمئات، وأحيانًا الآلاف، من المستوطنين باقتحام الأقصى في الفترة من ما بعد صلاة الفجر إلى عشية صلاة الظهر بشكل يومي؛ إذ بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى في العام 2021 أكثر من 34 ألف مستوطن، بزيادة حوالي 47% عن العام 2020؛ حيث اقتحم الأقصى حينها أكثر من 18 ألف مستوطن، وبزيادة 11% عن العام 2019؛ حيث اقتحم الأقصى حينها أكثر من 30 ألف مستوطن، ويعود انخفاض المقتحمين في العام 2020 إلى الإجراءات الوقائية التي ترافقت مع جائحة كورونا. وقد أصبح اقتحام الأقصى مكتسبًا لا يجري النقاش حوله، في حين أن منعه هو معيار فرض الإرادة الفلسطينية على إرادة الاحتلال.
نعم، لقد استطاع المرابطون وعشرات الآلاف من المصلين أن يمنعوا ترسيم التقسيم الزماني والمكاني وتقديم القرابين، ولذلك هناك إصرار على منع الاعتكاف طوال اليوم، أو حتى من صلاة الفجر حتى صلاة الظهر، وهو الوقت الذي تتم فيه الاقتحامات اليهودية، وقابلت إسرائيل هذا الاعتكاف باقتحام المسجد القبلي والمصلى المرواني فجر الجمعة الثانية من رمضان؛ حيث اعتقلت حوالي 500 معتكف، وأصابت أكثر من 150 آخرين. ولكن المرابطين، وحدهم، لا يستطيعون منع اقتحام المستوطنين للأقصى. لذا، من المبكر إعلان الانتصار الذي لن يتحقق إلا بوضع هدف إفشال التقسيم الزماني والمكاني على رأس الأهداف، وتجنيد كل الجهود والنضالات في مختلف الأماكن لتحقيقه.
تقديس العفوية والفردية والجهوية بدلًا من معالجة الأسباب
لعل نقطة الضعف المرافقة للهبات والموجات الانتفاضية والمواجهات العسكرية التي شهدناها منذ وقوع الانقسام وحتى الآن، هي غياب الهدف الوطني الكبير المراد تحقيقه في هذه المرحلة، والأهداف الملموسة التي يمكن تحقيقها في كل هبة وموجة، وصولًا إلى تحقيق الهدف الكبير.
إنّ ما يميز الهبات أنها تندرج في سياق ردات الفعل على العدوان، ومحاولات تنفيذ أهداف المخططات الإسرائيلية؛ أي أنها تندرج في إطار الدفاع عن النفس، ومعظمها ردود أفعال لا تندرج ضمن خطة وطنية واحدة تكون جزءًا من إستراتيجية واحدة، وهذا واقع لم تغيّره معركة سيف القدس، مع أنّها هزته بقوة. فلم تُستثمر هبة القدس وسيفها التي انتشرت داخل فلسطين بأسرها، ووصلت تداعياتها إلى كل أنحاء العالم بما يناسب التضحيات والبطولات إلا في تخفيف ظروف الحصار عن قطاع غزة، وتأجيل هدم المنازل وتهجير أهالي حي الشيخ جراح، وتبقى مهمة تحقيق الهدف الوطني الكبير مطروحة على جدول الأعمال الوطني.