معركة غزة الأخيرة وآفاقها المستقبلية
- الصفحة الرئيسية
- مقالات و تحليلات
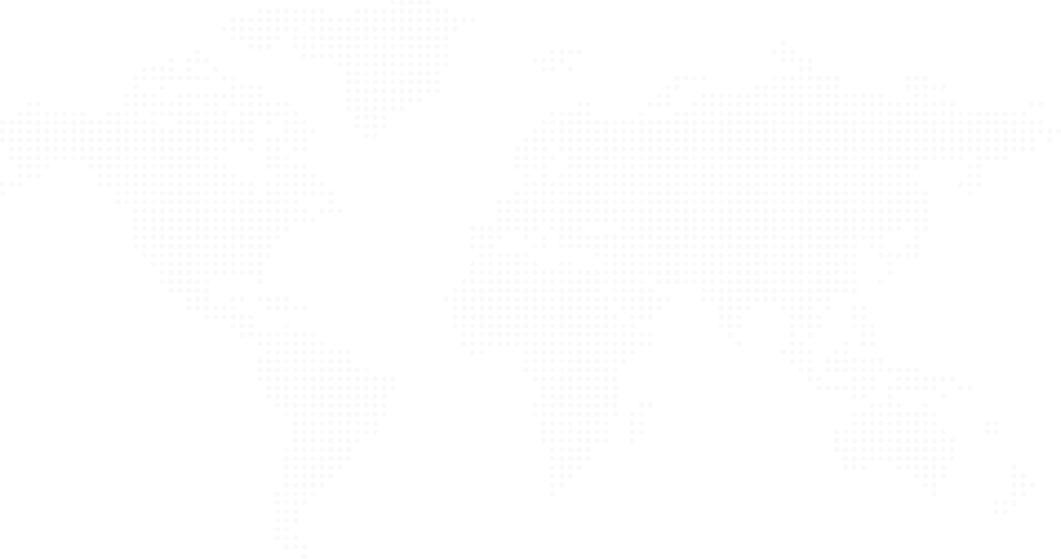
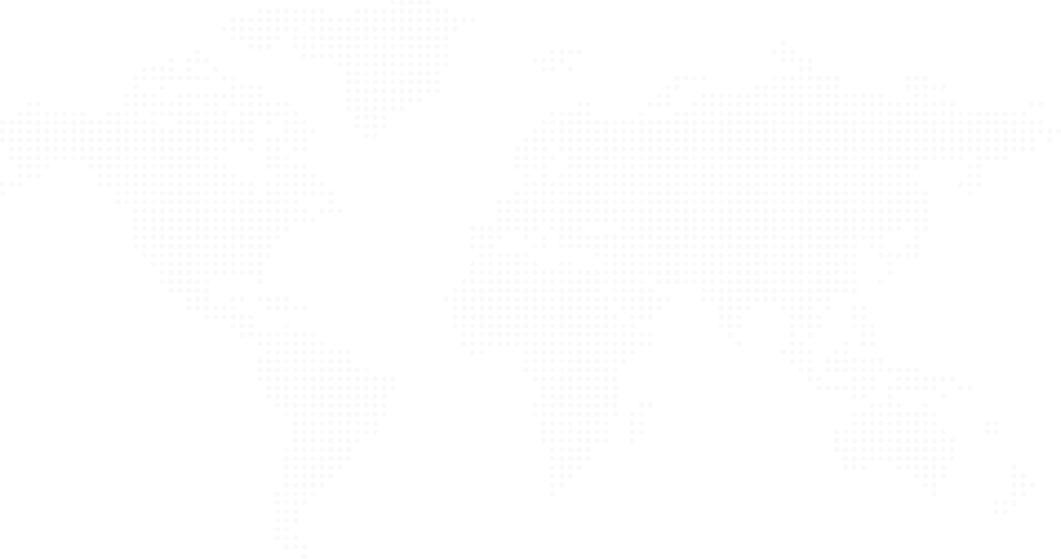

ترك العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة بين 10 و21 أيار / مايو 2021، جملة من الآثار السياسية والأمنية والعسكرية على الواقع الفلسطيني - الإسرائيلي، في ضوء النتائج التي أسفر عنها، سواء على صعيد العلاقات الفلسطينية الداخلية، وتغير موازين القوى بين الفصائل الفلسطينية، أو الانقلاب الذي شهدته الساحة السياسية الإسرائيلية بطيّ صفحة نتنياهو.
عدنان أبو عامر
السياقات العسكرية
جاء مفاجئاً للعديد من الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء، أن تبدأ المقاومة بردّها على مسيرة المستوطنين في اتجاه المسجد الأقصى يوم 28 رمضان، من خلال إطلاق صواريخ على القدس المحتلة، مباشرة، ومن دون أن يكون قصفها متدرجاً وبشكل تصاعدي مثلما جرت العادة، بحيث يبدأ بمستعمرات غلاف غزة، ثم بالمدن الفلسطينية الجنوبية المحتلة في عسقلان وأسدود، وصولاً إلى بئر السبع وتل أبيب، وانتهاء بالقدس. فقد جاء هذه المرة تنازلياً، على غير العادة، إذ بدأ القصف باستهداف القدس وتل أبيب، وانتهى بمستعمرات الغلاف.
يمكن التوقف طويلاً عند هذه الاستدارة الموضعية في أداء المقاومة، والبحث عن السبب المباشر الذي جعلها ترفع سقف هذه المواجهة مبكراً جداً من خلال استهداف القدس المحتلة، وما تمثله لدى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، الأمر الذي جعل حكومة نتنياهو الراحلة تشعر كأن ظهرها إلى الحائط، وتبدو مضطرة إلى الرد، وبأقصى قوة.
تفترض المقاومة أن الاستفزاز الذي أعلنه المستوطنون بالتخطيط لاقتحام المسجد الأقصى لا بد من أن يواجهه ردّ من المستوى ذاته، من خلال صيغة "الجزاء من جنس العمل"، ولا سيما أن المقاومة كانت أمام سباق مع الزمن لإفشال تلك المسيرة، ولن يوقفها إلّا استهداف القدس المحتلة بالصواريخ، بهدف تفريق جموع المستوطنين، ودفعهم إلى الاحتماء في الملاجىء. لكن حدثت في المقابل حالة من الاصطفاف الإسرائيلي شبه الكامل خلف المؤسستين السياسية والعسكرية في حربهما ضد الفلسطينيين، باعتبار أن المقاومة مسّت برمز له قدسية خاصة عند اليهود.
بدا لافتاً أن المقاومة استعدت جيداً لهذه المواجهة، من خلال المواظبة على رشقاتها الصاروخية طوال الأيام الأحد عشر، إلى الدرجة التي كانت تطلق فيها صليات بالعشرات في كل دفعة، مربكة عمل منظومة القبّة الحديدية التي لم تعتد على هذه الكثافة الصاروخية في مواجهات سابقة، فضلاً عن اتساع رقعة الهجمات الصاروخية الجغرافية، ودقتها التصويبية، والوزن التفجيري لتلك الصواريخ.
أمام هذا الواقع العسكري الذي أحرج الحكومة الإسرائيلية وجيشها، كثف سلاح الطيران ضرباته الجوية ضد عشرات الأهداف في قطاع غزة، حتى إنه اتّبع أشبه ما يكون بسياسة "الأرض المحروقة"، معيداً استنساخ "عقيدة الضاحية"، من خلال مشاركة نحو 160 طائرة في قصفها الجوي لبقعة جغرافية لا تزيد مساحتها على 360 كم2. لكن الغرض الإسرائيلي من هذه الكثافة الصاروخية، فضلاً عن ضرب منظومة الأنفاق الأرضية لـ "حماس"، كان تكبيد الحركة خسائر بشرية ومادية وتسليحية باهظة.
الأداء السياسي
منذ ما قبل اندلاع العدوان الأخير على غزة، ظهرت حالة من الانسجام بين المستويَين السياسي والعسكري لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فقد أصدرت المقاومة الفلسطينية عبر بياناتها والناطقين باسمها، وصولاً إلى قياداتها السياسية، تحذيرات إلى الحكومة الإسرائيلية بعدم السماح لمسيرة المستوطنين بأن تجري، وتمثل الاستعداد لتنفيذ التحذير في إصدار فصائل المقاومة الفلسطينية موقفها الموحد بأنها لن تصمت على هذا الاستفزاز، بل إنها ستنفذ تهديداتها على الأرض وستخوض هذه المواجهة.
في المقابل، بدا كأن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، الذي غادر أخيراً عرشاً تربّع عليه طوال 12 عاماً، أراد تمرير تلك المسيرة لأغراض انتخابية وحزبية بحتة، فقد فشل في تشكيل حكومته عقب التفويض الذي حصل عليه، ونجح خصمه يائير لبيد في تشكيل حكومة. ولعل نتنياهو أمل بأن تسفر المواجهة عن استقطابه قوى اليمين التي تحالفت بداية مع لبيد، ولا سيما نفتالي بينت، إلى صفوفه، من خلال ظهوره ملبياً مطالب المستوطنين المتدينين بتمرير مسيرتهم في اتجاه المسجد الأقصى.
لم تسفر هذه المسيرة عن تحقيق تطلعات نتنياهو بدليل ميلاد حكومة التغيير المناوئة له بعد مخاض عسير، كما لم ينجح في فرض انتخابات مبكرة خامسة بعدما قوّض الائتلاف المناهض له آماله بتشكيل الحكومة الجديدة، بل إن الإسرائيليين تولدت لديهم قناعات متزايدة بأن نتنياهو إنما خاض هذه المواجهة طمعاً في البقاء رئيساً للحكومة، وليس لاعتبارات أيديولوجية بحتة جعلها غطاء يتدثر به أمام الإسرائيليين.
أمّا المستويان العسكري والأمني، فكانا في حالة لا يُحسدان عليها بسبب القصف الذي شنّته المقاومة على قلب المدن الفلسطينية المحتلة، وقد تزامن ذلك مع توجهات الوسط السياسي. فقائد الجيش أفيف كوخافي اعتبر أن هذه المواجهة فرصة مواتية له لتنفيذ خططه العسكرية الموجهة ضد المقاومة الفلسطينية، ولا سيما خطة "تنوفا" الهادفة إلى توجيه ضربات "فتاكة" إلى المقاومين من خلال خطته تدمير ما سمّاه "مترو حماس"، الخاص بشبكة الأنفاق الأرضية، وهي خطة استطاعت المقاومة كشفها مبكراً، وإفشالها، وشكلت أحد الإخفاقات القاسية للجيش، ودفعت كوخافي إلى تشكيل لجنة تحقيق عسكرية.
فلسطينياً، على المستوى السياسي، ظهرت السلطة الفلسطينية غير ذات صلة بكل ما يحدث من معركة عسكرية طاحنة، باستثناء نداءات سياسية ودبلوماسية لم تكبح جماح العدوان الإسرائيلي، إلى الدرجة التي دفعت كثيراً من التقديرات الفلسطينية والإسرائيلية، بل الدولية أيضاً، إلى الحديث عن أن المقاومة الفلسطينية في غزة ظهرت مدافعة عن حي الشيخ جرّاح والمسجد الأقصى، بدليل استغاثة المقدسيين بها، وطلبهم منها وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
أكثر من ذلك، أظهرت المواجهة الأخيرة حالة من الانسجام بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، جغرافياً وسياسياً وحزبياً، ولعلها من المرات القليلة التي تظهر فيها هذه اللوحة الوطنية، سواء من خلال بروز حالة من التضامن بين فلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي الأرض المحتلة منذ سنة 1948، وصولاً إلى فلسطينيي الشتات الذين نظموا مسيرات في اتجاه فلسطين المحتلة، من الأراضي الأردنية واللبنانية.
توقف الفلسطينيون والإسرائيليون مطولاً عند هذه الحالة الاستثنائية من التضامن الشعبي والجماهيري الفلسطيني، والتي انطلقت من فرضية أساسية هي أن عنوان المواجهة كان القدس، وليس سواها، فكانت عنواناً جامعاً جديراً بالوحدة الوطنية، بينما كانت عناوين الاعتداءات الإسرائيلية السابقة تتعلق بحصار غزة، أو اغتيال قيادي من المقاومة، وهي مسائل تحظى بأهمية وتضامن، لكنها بالتأكيد لا تصل إلى قيمة القدس والأقصى.
ما بعد المعركة
ما إن وضعت الحرب أوزارها في غزة فجر 21 أيار / مايو، حتى بدأت أطرافها في البحث في تبعاتها ونتائجها على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية.
فسياسياً، مُني نتنياهو بانتكاسة كبيرة من خلال نجاح خصومه الألداء في تشكيل حكومة، والإطاحة به، بعد 12 عاماً متواصلة من الحكم، وخصوصاً بعدما ظهر أن مبادرته إلى خوض العدوان إنما كانت جسراً لبقائه رئيساً للحكومة، وهو ما فشل في تحقيقه.
قد يكون من التعسف القول إن حرب غزة وحدها، هي التي طوت صفحة نتنياهو وعهده السياسي، لكنها بالتأكيد تُعتبر مدماكاً أساسياً في هذا الأمر، ولا سيما بعد أن ظهر عجزه عن مواجهة المقاومة الفلسطينية التي فرضت حظر التجوال في العديد من المدن الإسرائيلية، وأغلقت خطوط الملاحة الجوية عقب تعطل الحركة في مطارَي بن - غوريون وميرون، فضلاً عن عدم توقف رشقاتها الصاروخية حتى اللحظات الأخيرة من العدوان.
يتداول الإسرائيليون فرضية فحواها أن نتنياهو أراد خوض مواجهة فعلاً مع المقاومة الفلسطينية من أجل تحسين ظروفه الداخلية بين أوساط اليمين، لكن الأمور بدت كأنها خرجت عن السيطرة: زمانياً، إذ إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية استُنزفت في 11 يوماً فقط، وجغرافياً، بعدم اقتصار القصف على مستعمرات غلاف غزة والمدن الجنوبية، بل وصولها إلى العمق السكاني الحقيقي في تل أبيب والقدس، لينقلب السحر على الساحر، وتُمنى إسرائيل بانتكاسة سياسية وعسكرية.
فور إعلان تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وأدائها اليمين الدستورية، حضرت غزة بصورة لافتة في خطابات رئيس الحكومة الجديد نفتالي بينت الذي وجّه تهديدات باستئناف الحرب، إذا ما لزم الأمر ذلك، وبالتالي التأكيد أن صفحة العدوان لم تُطوَ، وأنها قد تتجدد عند كل حدث، وخصوصاً في ضوء بقاء الأسباب ذاتها التي أدت إلى اندلاع الحرب الأخيرة، وهي: ترحيل سكان حي الشيخ جرّاح، ومسيرات المستوطنين في اتجاه المسجد الأقصى.
أمّا على الصعيد الفلسطيني، ففرضت المواجهة حالة من الانسجام الفلسطيني داخلياً وخارجياً، ورسمت لوحة عزّ نظيرها من الوحدة والتماهي والاصطفاف خلف المقاومة وردّها على الاستفزازات الإسرائيلية تجاه مقدساتهم. لكن هذه اللوحة، وللأسف الشديد، لم تعمّر كثيراً، وذلك بفعل السلوك الذي تبنّته السلطة الفلسطينية فور البدء بتطبيق وقف إطلاق النار في غزة، ورغبتها التي لم تُخفِها في السيطرة على مشاريع إعادة الإعمار في غزة من جهة، ورفض إشراك أي جهة فلسطينية فيها، والدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة من جهة أُخرى، الأمر الذي قوبل برفض فصائلي واسع.
إقليمياً، شكلت هذه المواجهة إيذاناً بكسر قرار غير معلن للإدارة الأميركية بعدم الاهتمام بقضايا المنطقة، وظهر هذا التوجه بعدم اكتراث الرئيس جو بايدن كثيراً منذ تنصيبه في 20 كانون الثاني / يناير، بالتواصل مباشرة برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيسَين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي، حتى جاءت الحرب على غزة، ففتح "خطاً ساخناً" مع الثلاثة، لتسريع إنجاز وقف إطلاق النار، باعتباره مصلحة أميركية للحيلولة دون توسع المواجهة خارج الحدود الفلسطينية.
وتجلّت آثار المعركة أيضاً، بحدوث تطور إيجابي على علاقة مصر و"حماس"، والتي شهدت في الأعوام الأخيرة حالة من المد والجزر. ففي الأسابيع التي تلت انتهاء العدوان على غزة، شهدت الاتصالات بين الجانبَين تنامياً متدرجاً بلغ إلى حد التواصل على مدار الساعة، بل حتى إلى دخول معدات هندسية مصرية إلى القطاع للمساهمة في إزالة آثار الدمار والهدم الذي تحقق بفعل القصف والهجمات الإسرائيلية، وإعلان مصر إنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار للبدء بإعادة إعمار غزة، وهذه خطوة لم تحدث عقب الحروب الثلاثة الأخيرة على القطاع خلال سنوات 2008 و2012 و2014.
بدورها، حاولت السلطة الفلسطينية اللحاق بركب الاتصالات والحراك السياسي الجاري في مرحلة ما بعد المعركة، وخصوصاً من خلال الجولات المكوكية التي قام بها رئيس الحكومة محمد اشتيه، وعدد من وزرائه إلى عدة دول عربية، ولا سيما الخليجية منها، لجلب التمويل الخاص بإعمار القطاع، في ضوء مخاوف السلطة الفلسطينية من توجهات عربية وغربية بعدم تحويل أموال إعادة الإعمار إلى خزينتها مباشرة بسبب التقارير التي تؤكد أن التحويلات السابقة لم تذهب إلى هدفها النهائي المتمثل في إعادة الإعمار، وهو أمر أعاق تلك العملية من جهة، وتسبب بخيبة أمل وغضب الدول المانحة من جهة أُخرى.
وبينما مثّل التضامن الفلسطيني منطلقاً لفتح صفحة جديدة بين الفصائل، فإن المسار السياسي الداخلي حقق فشلاً ذريعاً من خلال وقف الحوار الداخلي حتى قبل أن يبدأ في القاهرة، بعدما أصرت السلطة الفلسطينية على أن يكون مقتصراً على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، في الوقت الذي تمسكت "حماس" والفصائل المتحالفة معها بتوسيع قضايا النقاش، ولا سيما البحث في مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية، واستئناف الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة: تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، الأمر الذي دفع المضيفين المصريين إلى إعلان تأجيله حتى إشعار آخر.
بات من الواضح أن "حماس" تسعى لمراكمة إنجازها العسكري بحصاد سياسي يتمثل في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني، بعد أن أظهرت السلطة الفلسطينية عجزاً جلياً لا تخطئه العين خلال أيام العدوان على غزة. غير أن السلطة تسعى بصورة حثيثة، وبكل ما أوتيت من قوة، لحرمان "حماس" من تحقيق هذا الإنجاز، حتى لو تخلل ذلك الدخول في خلاف مع المصريين الذين أظهروا نوعاً ما تفهّماً لمطالب "حماس"، ولو بصورة مرحلية، كي لا يخسروا موطىء قدمهم في غزة.
استشراف المستقبل
شكلت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، استمراراً للسياسة العدوانية نفسها، وإن تميزت منها بالأسباب والنتائج. فالقراءة السياسية الاستشرافية للأحداث لا تشي بوجود ضمانات كافية بأن هذا العدوان لن يتجدد في أي يوم، ولأكثر من سبب وعامل.
فإسرائيلياً، نحن أمام حكومة جديدة تجمع بين ثناياها تناقضات كبيرة، سياسية وأيديولوجية وشخصية، وتتفق فقط على هدف إطاحة نتنياهو، وبالتالي لا يمكن استبعاد حدوث أي تطورات مفاجئة غير متوقعة، ربما يكون بينها شنّ عدوان على غزة، وإن كان ذلك يعني انهيار الحكومة، لأنها قد تفقد شبكة الأمان البرلمانية التي توفرها القائمة العربية الموحدة.
وثمة عامل إسرائيلي آخر لا يقل أهمية، ويتمثل في إصرار جماعات المعبد الاستيطانية على تنظيم مزيد من المسيرات اليهودية ذات الطابع الديني في ساحات المسجد الأقصى، والإمعان في استفزاز الفلسطينيين، والاحتكاك بهم، الأمر الذي لا بد من أن يقود في النهاية إلى وقوع اشتباكات في ساحات الأقصى على مدار الساعة، وضخّ وقود كافٍ لاندلاع مواجهة عسكرية جديدة.
أكثر من ذلك، فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تشعر بأنها مطالبة باسترداد بعض من ردعها الذي تبدد في الحرب الأخيرة، وربما تكون في صدد إعادة ترتيب أوراقها لاستئناف مواجهة عسكرية، وإن كانت قصيرة المدى، تتمثل في الحصول على ما تسميه "صورة انتصار" لم تحصل عليها طوال أيام العدوان الـ 11.
أمّا فلسطينياً، فتبدو "حماس" كأنها رسمت خطاً أحمر جديداً اسمه غزة - القدس، أي أن الأحداث التي قد تشهدها القدس من الجماعات الاستيطانية اليهودية، ربما تجد صداها لدى المقاومة في غزة، لجهة الرد عليها، وتحديداً عبر المقاومة المسلحة، مع أن ذلك قد يستنزف "حماس" ويُدخلها في مواجهات مسلحة بين حين وآخر، لأن اليمين الإسرائيلي بشقّيه: الديني والقومي، ماضٍ حتى النهاية في سياساته العدوانية تجاه مدينة القدس، أكان هذا في حي الشيخ جرّاح، أم المسجد الأقصى.
وفي غزة تحديداً، فإن بقاء مشاهد الدمار مثلما هي، والتلكؤ الإسرائيلي في السماح بإعادة الإعمار من خلال استمرار إغلاق المعابر، ومماطلة الدول المانحة في الشروع في مشاريعها الإنسانية، قد تصبّ مزيداً من الزيت على النار المتصاعدة أصلاً في القطاع، وتُنذر بتجدد متدرج للمواجهة التي ربما تندلع بأسرع ممّا نتصور.